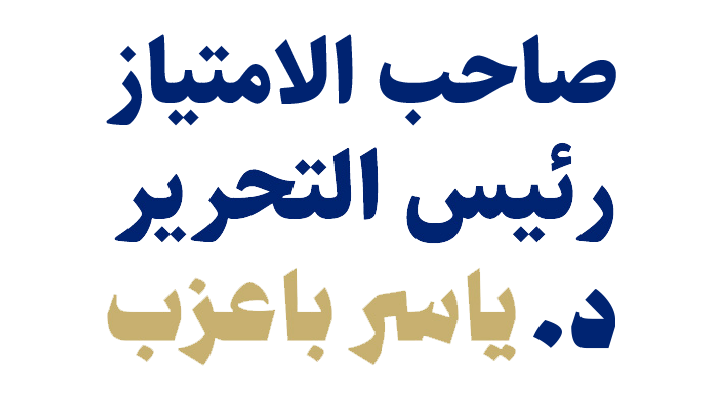كريستيانا الفاتِنة بيانُ الفِكرة وَ رخامةُ اللفظ قراءتي المُتواضعة لكريستيانا أديبِنا الفاضل( ناصر الوليدي)
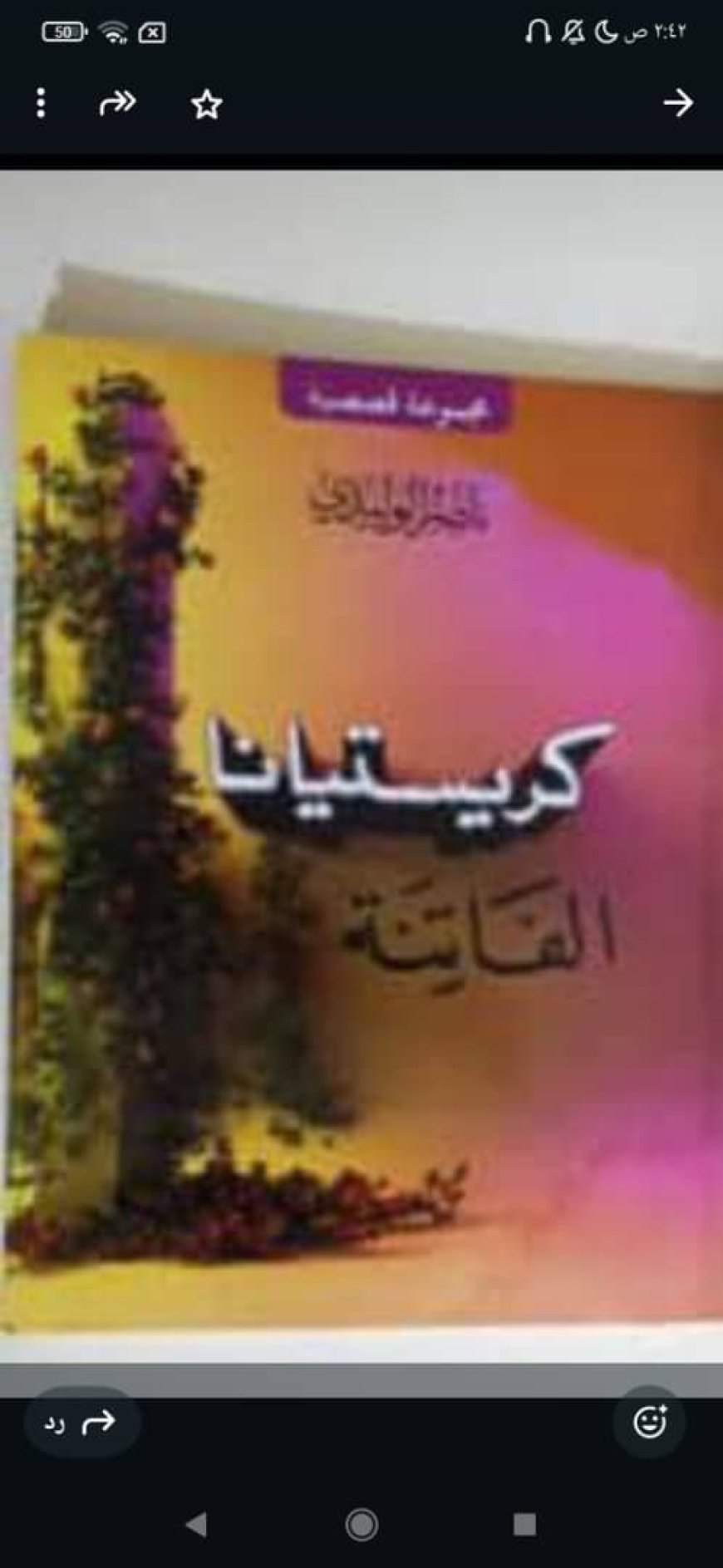
(أبين الآن) كتبت؛: أحلام الزَّامكي
إنَّنا لا نكتُب!
نحنُ ـ فقط- نُجيدُ البُكاء ؛ وإن كانَ بُكاءً مكتُومًا إلا أنَّ احمرارَ أحداقِ الورق ، وَ بحَّة حِبرِ الكاتِب وَشَت بندباتٍ هُنا لم تَزَل، و إن لم تَعُد تُؤلم.
بهذه المشاعرِ تُناغي هذهِ المجموعةُ وجدانَ قارئِها، بعشرينَ قصة بل عشرينَ وجهٍ مجتمعيٍّ ، حرصَ الكاتب أن يجعلَ صفحاتِها مرايا لألمٍ ، نعم لا زال هنا؛ إلا أنه أبرمَ معه عهدا ألا يفترقا ما داما .
إنَّ القارئ لهذه ( الفاتنة) أثناءَ قراءته ترتسمُ في مخيلته لوحةُ( بلا وسائل العيش) للفنان( ياكوف بروكوبييفيتش) ، وكأنَّ المجموعةَ مرسومةٌ في هذه اللوحة أو ربَّما العكس!
امرأةٌ شاحبةُ الملامح تجلسُ منكفئةًعلى نفسها ، غارقةً في مستنقع يأسِها وبأحضانِها طفلُها النائم بأجفانٍ لا تُصالِحُها الأحلام، كلُّ شيءٍ في اللوحة يصرخُ بوجعٍ وصمتٍ وَ عجز ، العجزُ ذاتُه الذي نشيحُ بوجهنا عنه خجلا بعد كلِّ قصةٍ نقرؤها هُنا .
???? أولًا : الموضوع.
صوَّرَت ستة عشر قصة من المجموعة قضايا المجتمع تصويرا فوتوغرافيا مطبوعا ، بينما أربع قصص توزَّعت في ميولِها بين الديني و التوعوي كما في قصص( كريستيانا الفاتنة، وحي العقبة،الطفل القندهاري، ومُثلث الإرهاب)
بينما ناقشت بقيةُ القصص موضوعات اجتماعية تتعلَّق بضحايا الحروب بحثا عن لقمة العيش كما في( شجرة أم مازن) التي توغَّل فيها الكاتب بذكر تفاصيلٍ حياتية تُدخِلُ القارئَ في جو القصة واقعًا ، وكأنه عاشها فعلا ،هذا إن لم يكن فعلا قد عاشَها قَبلا.
و تطرَّق الكاتب لموضوع ( اليُتم) كما في ( آمال) وسردَ المشاعر التي تخالجُ مَن أصابته وعكة ذاك الشعور ، و عرَّج على موضوع فرعي وهو أن الألم حالةٌ قد تُوصف لكنها لا تُنقل بذاتِ الشعورِ للآخرين مهما كان الوصفُ ناقلا بليغا وصادقا و حقا كما يقولون:" شتَّان بين النائحةِ الثكلى والنائحةِ المُستأجَرَة"
و طرقَ الكاتبُ أبوابَ الحبِّ على خجَل في أربعِ قصص وهي( شارع الفتاة فردوس) الحكاية ذات الطابع الصوفي ، الذي صوَّرَ فيه الكاتبُ حالةً غير طبيعية في الحب ؛ ربما تجعل الرجلَ المُتديِّنَ الحكيم عاشقا طائشا .
و عاد الكاتب للحديث عن الحب في قصة( ماء الورد) حكاية صابر وفاطمة ، وكيف أنَّ الحبَّ يغدو ضعيفا مُرتجِفًا حين يُطلب منه أن يقولَ كلمتَهُ أمامَ هيبةِ القدر ، حينها لا يكونُ بوسعه إلا أن يطلبَ أن يُرَشَّ على قبره بعدَ موتِه( ماء الورد) .
وتحدَّث الكاتبُ عن الزواج الفاشل حين يكونُ الحبُّ والاهتمام من طرفٍ واحد، وعندما يفشلُ أحدُ الشريكَين في إيجادِ بوصلة الشراكة ؛ فتضيعُ الوجهة حين ينعدمُ التوافق الروحي بين الشريكَين كما في( الخطاب المختبي).
أما في( مستحيل مُمكن) الحكاية التي لها شبيه في ( ألف ليلة وليلة) على اختلافِ بعض تفاصيلها ، إلا أن المستحيل الممكن هنا جاء بعمقٍ فلسفي ، يراها العاطفي فلسفةً ممكنة ،ويجدُها المنطقيُّ فلسفةً عمياء، لكنّها هنا استراحةـ نوعًا ما ـ لشهرزاد بتركِ دفة الكلام هذه المرة للملك شهريار.
وتناول الكاتبُ موضوع انعدام الخدمات ومعاناة الناس لاسيما في الأرياف كما في( ليلةالزين) بتفاصيلها الخانقة التي تجعلُ القارئ يستدرُّ السطور لإنهاء معاناة الأم الحامل.
وفي( أبي الطفل) كان حديثُ الرجل المُسن يشبه حديث طفلٍ لازال متشبثا بطرفِ رداء أمه، ذلك الرداء الذي نظلُّ متشبِّثينَ به، وإن بلغنا من العمر ما بلغنا.
وعرَّج الكاتب على موضوع القتل الخطأ والطيش والندم والتسرع الذي يرمي صاحبه في المهالك كما في( بالخطأ) .
و ذكرَ الكاتبُ موضوع الإعانات والكرامة المسكوبة بأعتاب الإغاثات التي تُعطى للناس ؛ ثمنا لأوطانهم المسلوبة ،وذكرياتهم المبتورة عنهم قسرا كما في حكاية أم سعيد في( دموع الذكريات).
كما ذكرَ الكاتبُ تلميحا موضوعا أمميًا عربيًا نجده في حوارٍ عذب مع محمد صوالحة حولَ حتميةِ العودة لفلسطين فاتحين، كما في( وحي العقبة)
وأشار الكاتب لقضية ( التسول) كظاهرة مجتمعية بجانبٍ إنساني نفسي ومختلف،بذِكرِ خطأ التعميم في هذه القضية ، فليس التسوُّل عملًا مُرحَّبًا به من قِبل المزاولين له دائما ، فهناك الكثير ممَّن أُرغِموا على مزاولته كمهنة للنَّصب ؛ وهذا حالُ طفلتنا في ( سنوات الضياع).
وبارتباطٍ طفيفٍ مع هذه القضية سارَ الكاتبُ على بُعد خطوتَين فحسب؛ ليرصدَ عن قُربٍ مسألةَ العبودية كما في حال أبي عبدالرحمن وهو ( على ظهر الناقة) باعتبارِها باب لتحرير الفِكر ، و أن المُستعبَدين هم أكثرُ مَن يُقدِّر ثمنَ الحرية ، لأنهم دفعوا ثمنها باهِظا .
و عمدَ الكاتبُ إلى إلقاء نظرةٍ بمعنى نفسي أيضا حين لفتَ عُنُقَ انتباهِنا نحو نفسياتِ الناجِين من الحوادث لاسيما الأطفال كما في( يوم أليم) ،
وإلى ظلم الأقارب كما في( الراحلون) الحكاية ذات الطابع الوصفي المُكثَّف، وكأنَّ السِّترَ قد أُزيل عن الكاتب لحظةَ الكتابة ؛ ليستدعي ذلك الوصف بكل حذافيره المقززة أحيانا ، إلا أن تلك التفاصيل جاءت مواكِبةً للبناء الدرامي للحكاية.
كما نلحظُ التمييزَ بين الأبناء في( البداية)،و ضرورة الحفاظ على مبادئنا و إن دفعنا أثمانَها من سعادتنا ووجودنا كما في ( مثلث الإرهاب) .
أما ( الطفل القندهاري) فالقارئُ لها تصِلُهُ علاقة الكاتب وارتباطه النفسي، وربما ذكرياته في أفغانستان و صلتهُ بها في فترةٍ ما ؛ بأناشيدها و رباطِها وجهادِها ، ليأتي كتاب( بين الأنهار الخمسة) للكاتب دالًا على تلك العلاقة الحميمة مع ذاك البلد أرضًا وإنسانًا.
أما القصة الأيقونة( كريستيانا الفاتنة) فالقضية التي تناقشها بألف قضية ؛ وهي غيابُ الدعوة إلى الله ،و العتبُ على المسلم حين يرضى بدَورِ المُتلقِّي لا المُبادِر.
إذًا فمِحورُ العمل الأدبي اجتماعيٌّ، ديني ،نفسي، واقعي.
????ثانيًا : النَّوع.
يُمثِّل هذا العمل الأدبي القصةَ القصيرةَ باشتراطاتها و بنودِها وشخصياتها: وإن كانت تفتقرُ إلى ( عنصر الحل) أو ( الانفراجة) فنلاحظ أنَّ كلَّ قصة تمثِّلُ عُقدةً مجتمعية لا تظفرُ بِحَل ، وهذا ما يتواءمُ مع ما ذهبَ إليه الموضوع، وما افترضه الواقع ؛ الذي جعلَ الكاتب يتعاطى مع القضايا دون تقديم حلول و لا تحقيق نتائج .
????ثالثًا: المضمون.
يمكن القول إنَّ الأفكار والمشاعر والتوجهات والمعتقدات والأحداث في هذا العمل الفني مكرورةٌ ؛ إلا أنَّ هذا التكرار يحقِّقُ ألفةً لدى القارئ تمكِّنهُ من تمثُّلِ الحدث الدرامي، وتُشعِرُهُ أنه جزءٌ منه، فيلوحُ له وجهُهُ في الخلفية القريبة لكل قصة ، يتعايشُ مع مضامينها؛ لأنها تخصُّه ؛ بل هي هو مطبوعة على الورق.
وعلى الرغم إنَّ هذه ميزة ؛ إلا أنها تُقَوِّضُ خيال الكاتب، وتكبحُ جماحَ الماورائيات التي يتوقُ القارئ إلى التوقف قليلا لسَبر كُنهها، كما أنها تلوي يدَ المُزايدات المحمودة المحببة لدى القارئ، لكنَّ الكاتب آثرَ ألا يدخُلَ غمارَها ؛ فقصرَ وظيفته ـ فقط ـ على إمالةِ المرايا نحو وجوه المجتمع ؛ لتظهرَ تلك الوجوهُ على الورق صادقةً حقيقية بلا زخرفٍ ولا تجميل.
????رابعًا: اللغة والأُسلوب.
نلحظُ أنَّ لغةَ الكاتب تتنفَّس بُكُورَ المُفردات بلا تكلُّف إيقاعيٍّ، أو تسلُّق أسلوبي، أو اجترارٍ تركيبي، وگأنَّ الكاتب يُؤَثِّثُ بيتَ مجموعته من سَعفِ البيان ، و أعمدةِ التصوير المباشر ؛ فيفرشُ ملاءةَ المعنى دون حاجةٍ لغطرسةِ التوريات، وَ جُبنِ الاستعارات ؛ فجاءت لغةُ العمل سهلةً، سلسةً،عميقةً ومُعبِّرة، وفي ذات الوقت حيةً تتشكَّلُ أول ما تتشكَّل على هيئةِ نَدبة بارزة .
????خامسًا : التِّقنيَّات .
جاءت تقنياتُ المجموعةِ متواضعةً ، تخلو من القفزاتِ التكتيكية ، ومن التخطيطِ التراكُمي ، ومن السردِ الدرامي المُفتعَل؛ رغمَ صلاحيةِ الأحداث لهذا النوعِ من البناء الدرامي ذي النزعةِ التراجيدية؛ فالكاتب كان قادرا على تحويلِ تلك الندبات المجتمعية غير المؤلمةـ وإن دلَّت على ألمٍ قديم ـ إلى جراحٍ حية متجددة ، حديثةِ التفجُّر ؛ وربما هذا ما كان سيجعلُ المجموعةَ أكثر تأثيرا و ملامسةً لجراحٍ مشابهةٍ في قلب القارئ.
????سادسًا: السِّياق.
ذكرَت المجموعةُ عنصرَي( الزمان والمكان) بشكلٍ ما في بعض القصص ، وإن كان غير مُصرَّحٍ بهما في بعضها الآخر ، ولعل هذا يرجعُ لقلةِ الحاجة لذكرهما في كل قصة؛ لأنَّ الأحداث جاءت دالةً على نوع المجتمع ومكانه وزمانه الحاضر ، حين جعلَ الكاتب من السياق شاهدا على هذين العنصرين.
أما عنصر( الثقافة) فجاء واضحا جليا منتشرا في كل قصة؛ فأظهرَت المجموعةُ ثقافةَ الكاتب في أكثر من مجال كثقافته( المجتمعية والجغرافية والدينية والصوفية والأدبية) وإن كانت ثقافتُهُ( الإسلامية) منثورةً أكثر بطابع توعوي فريد في كل قصة تقريبا ، ومنها تفرَّعَت بقيةُ ثقافات الكاتب.
????سابعًا: التَّأثير.
لم يكن ( التأثير) في أَوجِه ،ويرجع هذا لسببين:
????الأول: إنَّ المُتلقي ( القارئ) اليمني خاصة، والعربي عامةً ربما تآلفَ مع الألم اليومي المسرود في المجموعة ؛ لأنه واقعٌ يقتاته يوما بعد يوم ، وهذا ما أفقدَ المجموعة خيطَ( المفاجأة) الذي يبحثُ عنه القارئ في كل ما يقرؤه.
????الثاني: إنَّ الكاتب نفسه تجاهل أثناءَ كتابته المبالغةَ في توقيع الحزن، ولعله أراده عملا أدبيا واقعيا يمثِّل المجتمع دون بكائيات مُفتعَلة أو جُمل نائحة أو عبارات منكوبة، وإن كان الواقعُ منكوبا حقيقةً.
????ثامنًا: القيمة الأدبية.
تمثِّلُ المجموعة صورا مُبروَزةً كقوالبَ جاهزةٍ للمجتمع ؛ تحملُ قيمًا نبيلة؛ تتمثل في الإحساس بما يعتلج صدورَ الآخرين وما يعتريهم وما يعانونه من فقرٍ ويُتمٍ، وما يكابدونه من تباريحِ الحب والألم ، وما يؤرقهم من شظف العيش والافتقار لأبسطِ الخدمات لاسيما في الريف، والبحث عن لقمة العيش التي تجلب الموت لصاحبها ربما، كما تنبع قيمة العمل في الإيغال في ذِكر التفاصيل كالخوف الذي يلازمُ الأبناء على أمهاتهم وإن كبروا وأصبحوا آباءً وأمهات، كما أشارت المجموعة لقيمة دينية نبيلة ك( الدعوة إلى الله) وإلى أن يكونَ المسلمُ فاعِلًا لا مُستقبِلًا سلبيا، كما عرج الكاتب إلى قضايا القتل الخطأ والطيش والندم وانعدام التوافق الروحي بين الزوجين الذي قد يُفشِلُ الزواج ، وعن قيمة الانتماء إلى ديننا والارتباط بمقدساتنا الإسلامية وحبنا للقدس ومكانتها في قلوبنا.
وعن قيمة العزة وكراهية ظاهرة التسول وتقديمها من زاويةٍ إنسانية نفسية، كما تطرق الكاتب لقيمة( الحرية ورفض التبعية) و ضرورة الانتباه لبعض التفاصيل النفسية التي لا ينتبه إليها أحد ربما كمخلفات الحوادث ونفسيات الناجين منها، كما ألمح الكاتب إلى قيمة ( الثبات الانفعالي) وضرورة دفع أثمان مبادئنا مهما كانت غالية ، كما ذكر الكاتب قيمة المساواة بين الأبناء وعتبَ على التمييز بينهم ، و حذَّر من ظلم الأقارب و أرسى قيم المحبة والتآلف والتعاطي مع الناس بمختلف ألوانهم وشرائحهم.
الخُلاصة✉️⭐
قدَّمَت المجموعة مفهوم( الألم) بصورةٍ نمطية فرضَها المجتمع على الكاتب لا العكس؛ فهو أي ( المجتمع) المادة الخام التي استمدَّ الكاتب منها أدوات هذا العمل ، ومن الملاحَظ أن التعبير عن فكرة الألم هُنا تُغاير الفكرةَ التي يرسمُها بعض الغربيين في جعل (الألم) مادةً تزود أصحابها بوقود الحياة لا اليأس ؛ فهي تمكنه من ممارسة طبيعتهِ تلك بصورةٍ مسموحٍ بها ضمن إطاره البشري ؛ حيث يقول( بودلير) :" الإنسان قد وُهبَ موهبةَ الشعور بالألم ، ولا أعتقد أنَّ الحياةَ ستكونُ عادلةً إن نحنُ تجاهلنا ذاكَ الألم" .
ويمكن القول إنَّ الأنماطَ الكُبرى التي تُوجِّهُ العمل الفني عامةً ، والفنيَّ خاصةً قد تختلفُ من مجتمعٍ لآخر ؛ بل من شخصٍ لآخر، كما أنها تأتي تأريخًا لأشكال مجتمعاتِ أصحابها، وهنا نحكمُ على ( مصداقية) العمل ؛ حين يكونُ قادرا على سَبرِ دائرته الصغرى المتمثلة في طابع مجتمع الكاتب ، ثم تناوُل بقية الدائر الكبرى الأبعد منه ) فنًا و أدبًا .
ومن الجدير بالذكر أن الكاتب امتلك أهم ما يملكه الكاتب وهو( البيان) الذي بشَّرَ به الجاحظ بقوله:" " والدلالة الظاهرة على المعنى الخفي هو( البيان) الذي سمعتُ الله عز وجل يمدحه، ويدعو إليه و يحثُّ عليه . بذلكَ نطقَ القرآن ، وبذلك تفاخرَت العرب".
????الخِتام.
⭐ إنَّ أصابعَ الشعور بعد كلِّ قصةٍ هُنا تُشيرُ إلى الأوطان المُتعَبة ،والمُتعَب أهلُها، وگأنما استدعتها كلماتُ الشاعر( حسن عامر):
بلادي
تذكَّرتُها في عُيونِ المسافرِ ليلًا،
بكيتُ!
وكانت لرغبتِها في الرحيلِ انتهَت، وانتهيتُ
تذكَّرتُها؛
فانحنى الدمعُ مستسلما ، وانحنيتُ
بلادي التي ما اكتفَت من بُكائي،
و مِن حُزنِها ما اكتفيتُ.
⭐نشكرُ كاتبَنا المتألق لإبداعه الفريد ، ونرجو لهُ التوفيق، ومنهُ مزيدا من ضياءاتِ العطاء الأدبي العذب.
أحلام الزَّامكي????