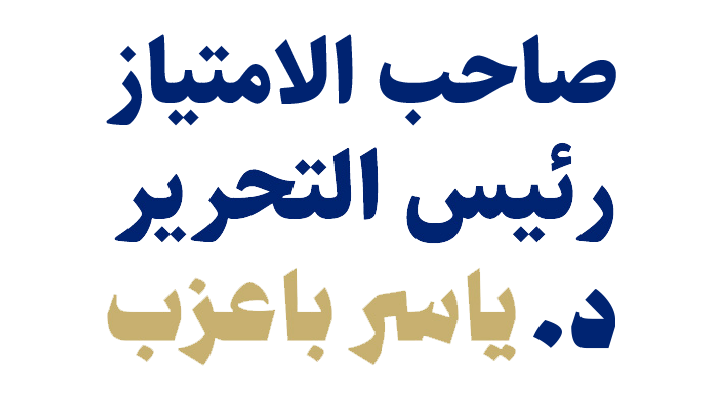علي أحمد باكثير: رائد الشعر الحر والدراما العربية - حياة مفعمة بالإبداع وظلم مستمر

(أبين الآن) سالم عبدالله باعشن
علي أحمد باكثير (1910-1969) كان واحدًا من أبرز الأدباء والشعراء العرب في القرن العشرين، ورائدًا من رواد القصيدة العربية الجديدة أو ما يُعرف بالشعر الحر، كما كان أحد أهم كتاب المسرح العربي. وُلد باكثير في مدينة "سورابايا" بإندونيسيا، حيث كانت الجالية الحضرمية تقيم، وعاد إلى وطنه الأصلي حضرموت في سن العاشرة، ليعيش فيها حتى عام 1932. تنقل باكثير بعد ذلك بين عدن (1932-1933)، والحجاز (1933-1934)، واستقر أخيرًا في مصر (1934-1969) حيث قضى الجزء الأكبر من حياته، وأنجز معظم إبداعه الأدبي.
حياته وإبداعه
علي أحمد باكثير كان مبدعًا متعدد المواهب؛ فهو شاعر بارع، وكاتب مسرحي رائد، وروائي. في مجال المسرح، ترك باكثير عددًا من المسرحيات الهامة التي ساهمت في تطوير الدراما العربية، مثل "هاروت وهاروت"، "ملحمة عمر"، و"جلفدان هانم". هذه الأعمال المسرحية كانت سببًا في شهرته وذيوع صيته في الأوساط الأدبية العربية. بالإضافة إلى ذلك، كتب باكثير في عالم القصة والرواية، مسجلاً بذلك حضورًا قويًا في مختلف جنسai الأدب.
في الشعر، يُعتبر باكثير أحد رواد قصيدة الشعر الحر، التي ساعدت على تشكيل المشهد الشعري العربي الحديث. تأثر باكثير بالآداب الأجنبية التي ترجم منها، واطلع على تجارب شعرية عالمية، فكان من أوائل من صاغوا النماذج الأولى لقصيدة الشعر الجديد في العربية. تخرج باكثير في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب في جامعة القاهرة، وقد ساعدته دراسته للغة الإنجليزية على الاطلاع على الأدب العالمي وترجمة بعض الأعمال، مما أثرى تجربته الإبداعية.
الظلم والتهميش
على الرغم من إنجازات باكثير الأدبية الكبيرة، إلا أنه ظُلِم في حياته وبعد وفاته. كان باكثير ملتزمًا بآرائه العروبية والإسلامية، وهذا جلب عليه عداوة اليمين واليسار معًا في مصر. عانى باكثير من تهميش إبداعه المسرحي، حيث مُنعت مسرحياته من العرض أو أوقفت بعد تقديمها، بسبب مواقفه السياسية والفكرية. بالإضافة إلى ذلك، لم يُعْنَ باكثير بنشر دواوينه الشعرية في حياته، وظلت قصائده حبيسة أوراقه ولم تنل حقها من الانتشار والتقدير.
جهود إنصاف باكثير
كان للدكتور محمد أبوبكر حميد، أستاذ الأدب الإنجليزي بالجامعات السعودية، دور كبير في إنصاف علي أحمد باكثير. الدكتور حميد، وهو حضرمي مثله مثل باكثير، كرس أكثر من ثلاثين عامًا من حياته لجمع وتحقيق ونشر تراث باكثير المجهول. فقد أصدر ديوان "أزهار الرُّبا في شعر الصبا" الذي يضم شعر باكثير في المرحلة الحضرمية (1923-1932)، وديوان "سحر عدن وفخر اليمن" الذي يصور المرحلة العدنية (1932-1933). ويعمل حاليًا على إعداد ديوان "وحي ضفاف النيل" الذي يجمع شعر المرحلة المصرية (1934-1969). أصبح الدكتور حميد مرجعًا أساسيًا للباحثين في أدب باكثير في كل أنحاء العالم، وساهمت جهوده في إعادة الاعتبار إلى هذا الأديب الرائد.
مضامين شعره
شعر علي أحمد باكثير عالج مجموعة من الهموم الوجدانية والتاريخية والقومية والروحية. من أبرز ما ميز شعره فجيعته المبكرة في زوجته الشابة التي كانت ملهمة شعره العاطفي والبكائي. كما صور باكثير أحوال الحضارمة في الوطن وفي المهجر (جزر الهند الشرقية)، وتناول انقسامهم إلى طائفتين متنازعتين، وهو الأمر الذي شغله كثيرًا في مراحل حياته الأولى. وفي مرحلته المصرية، انشغل باكثير بالهم القومي العربي والإسلامي، فصاغ بكائيات مؤثرة في رحيل أعلام الأمة مثل حافظ إبراهيم وأحمد شوقي، رغم أنه لم يكن قد زار مصر وقت وفاتهما. من أبرز قصائده "إما نكون أو لا نكون" (1967)، التي كتبها في أعقاب نكسة 1967، وهي قصيدة ملحمية تعبر عن صرخة مدوية لاستنهاض همة العرب والمسلمين، وتنبيههم إلى خطورة الوضع. في هذه القصيدة، استخدم باكثير عبارة "إما نكون أو لا نكون" كمرجع إيقاعي يختتم به كل مقطع، مؤكدًا على ضرورة الاختيار المصيري بين الوجود الفاعل والانهزام.
اللغة الشعرية
اعتمد باكثير في لغته الشعرية على التراث اللغوي العربي، مع تأثر واضح بلغة الإحيائيين (مثل شوقي وحافظ)، وكذلك بلغة الشعراء الثوريين والطليعيين في عصره مثل عبدالرحمن الشرقاوي وعبدالرحمن الخميسي. رغم أنه كان من رواد الشعر الحر، إلا أنه لم يبتعد كثيرًا عن اللغة الشعرية التقليدية، وصاغ قصائده بنفس ملحمي وروح عروبية وإسلامية واضحة. عمل باكثير بالترجمة ساعد على توسيع أفقه الشعري وإدخال عناصر جديدة على صياغته الشعرية.
خاتمة
علي أحمد باكثير كان أديبًا كبيرًا ومبدعًا حقيقيًا، ظُلِم في حياته وبعد مماته بسبب آرائه ومواقفه. لكن بفضل جهود أمثال الدكتور محمد أبوبكر حميد، بدأ باكثير يحصل على بعض من حقه في التقدير والإنصاف. ترك باكثير إرثًا شعريًا ومسرحيًا يمثل إضافة نوعية للأدب العربي الحديث، وتظل أعماله شاهدة على إبداعه وريادته في مجالي الشعر والدراما.