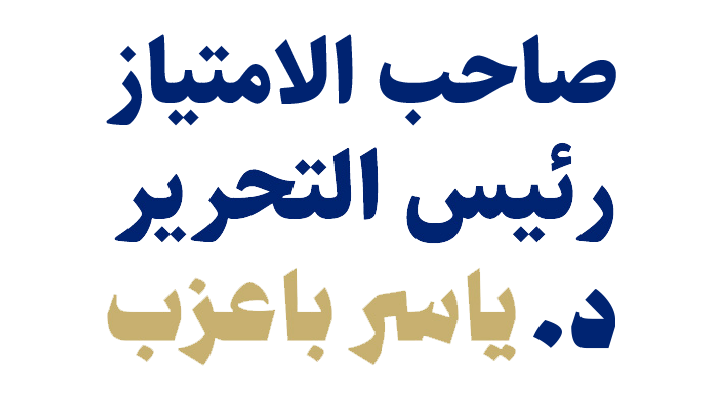تداعيات خفض التمويلات الدولية على مشروعات المياه بالدول العربية

(أبين الآن) متابعات
كتب: الصغير محمد الغربي
في واحدة من أكثر مناطق العالم جفافًا، باتت مشروعات المياه في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه مستقبلًا يكتنفه عدم يقين بشأن التمويلات الدولية.
خلال الأعوام القليلة الماضية شرعت عدة جهات مانحة رئيسة في خفض تمويلاتها لبرامج المياه، ما يُلقي بظلال من الشك على استمرارها، وينذر بآثار سلبية محتملة على جهود تأمينها في دول تعاني الإجهاد المائي وتأثيرات تغيّر المناخ.
في المغرب وتونس ومصر ولبنان والأردن وغيرها من دول المنطقة، تُعد مشروعات المياه من بين الأكثر أولوية، لا سيما مع تزايُد تحديات تأمين المستخدمة منها في الشرب والزراعة، غير أن عددًا معتبرًا منها يعتمد على التمويل الخارجي لتنفيذ برامج التحلية، وإعادة الاستخدام، وتحسين الإدارة.
ومع دخول مرحلة الغموض التمويلي هذه، تُطرح تساؤلات جادة حول قدرة الحكومات والمؤسسات المحلية على سد فجوة التمويل، وضمان استمرار جهود مواجهة ندرة المياه، خاصةً في ظل النزاعات الإقليمية والضغط السكاني.
موجة انسحاب تمويلي عالمي
بُعَيد تنصيب دونالد ترمب رئيسًا، بداية العام الجاري، أعلنت إدارته إلغاء أكثر من 90% من عقود الدعم الخارجي الخاصة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تقدر بنحو 60 مليار دولار.
ولئن كان هذا الإجراء هو الأبرز إعلاميًّا، باعتبار أن ”الوكالة الأمريكية تؤمِّن ما يصل تقريبًا إلى 40% من مجمل المساعدات الدولية“، وفق عصام الخطيب، الخبير الدولي في التنمية المستدامة، فإنه لم يكن حالةً استثنائية، بل له نظائر وأشباه في دول أوروبية كبرى.
فرنسا مثلًا أعلنت في مارس الماضي خفضًا بنسبة 35% في موازنة المساعدات الإنمائية الرسمية المخصصة لتمويل أنشطة الوكالة الفرنسية للتنمية.
وفي المملكة المتحدة، صرح رئيس الحكومة مؤخرًا بعزم بلاده تقليص مخصصات المساعدات الخارجية من 0.5٪ إلى 0.3٪ من الدخل القومي الإجمالي بحلول عام 2027 لصالح دعم الإنفاق الدفاعي.
أما الحكومة الهولندية، فأعلنت منذ عام 2023 أنها ستقلص تدريجيًّا موازنة المساعدات الإنمائية من 6.1 مليارات يورو (تقديرات 2029) إلى 3.8 مليارات يورو.
يقول الخطيب لشبكة SciDev.Net: ”13 دولة مانحة رئيسة من أصل 17 خفضت التزاماتها منذ عام 2022، في دلالة واضحة على منحى تنازلي يعكس أزمة عميقة تتطلب تحركًا إستراتيجيًّا من الدول المتلقية للدعم“.
هذه الموجة من التخفيضات تمثل تهديدًا مباشرًا لمشروعات المياه في بعض الدول العربية، ومع تقلص الموارد، صارت هذه الدول تتنافس على حصة آخذة في الانكماش، مما يهدد بإيقاف بعض المشروعات أو إرجائها.
يجري هذا في الوقت الذي تتزايد فيه حاجة تلك الدول إلى الدعم لتنفيذ مشروعات أساسية تمكنِّها من توفير احتياجاتها من مياه الشرب والري، وتحسين إدارتها وتنويع مصادرها.
بالأردن الأزمة مركبة
تواجه الموارد المائية في الأردن ضغوطًا متزايدة لا تتناسب وحجم السكان الحالي، وفق الأردنية ميسون الزعبي، الخبيرة الدولية في دبلوماسية المياه والمياه الدولية.
وتستطرد: ”موارد المياه الطبيعية المتاحة لا تكفي بالكاد سوى 3 أو 4 ملايين نسمة، في حين يبلغ عدد السكان نحو 12 مليونًا، نتيجة موجات النزوح واللجوء المتعاقبة منذ مطلع القرن الماضي، ما أدى إلى زيادة الطلب على المياه بما يفوق قدرات الدولة“.
والتغيرات المناخية تُفاقِم أزمة المياه في الأردن، من خلال تقلبات التهطال وارتفاع درجات الحرارة، وتكرار الفيضانات المفاجئة، وهي عوامل تضرب مصادر المياه التي هي شحيحة أصلًا، وفق ميسون.
يُصنف الأردن بين أكثر دول العالم فقرًا مائيًّا؛ فحصة الفرد السنوية أقل من 100 متر مكعب، مقارنةً بخط الندرة المائي العالمي البالغ 500 متر مكعب، وفق وليد صالح، كبير مسؤولي البرامج بالمكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا بالمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ”ما يجعل من أي مشروع مياه جديد ضرورةً إستراتيجية“.
لهذا، يحظى قطاع المياه في الأردن بأولوية قصوى واهتمام كبير، وبدعم ملحوظ من الجهات المانحة.
توضح ميسون أن جل مشروعات المياه -مثل تحسين الإدارة وتقليل الفاقد وإنشاء محطات معالجة الصرف البالغ عددها 30 محطة- تعتمد كثيرًا على التمويل الدولي، لا سيما الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومؤسسات أخرى.
والوكالة الأمريكية أحد أبرز الداعمين لمشروعات المياه في الأردن، لا سيما الخاصة بالبني التحتية، مثل خفض الفقد المائي.
ومن المشروعات المستقبلية الكبرى التي تدعمها الوكالة مشروع الناقل الوطني للمياه ’العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه‘، المخطط إتمام إنجازه قريبًا لحل أزمة شح المياه خلال السنوات القادمة، طاقة الإنتاج عند دخوله حيز التشغيل تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويًّا، لتلبية احتياجات حوالي 4 ملايين نسمة، عبر خط أنابيب بطول 450 كيلومترًا.
لكن تمويل هذا المشروع الإستراتيجي تراجع نتيجة القرارات الأمريكية الأخيرة، مما دفع الحكومة الأردنية إلى البحث عن بدائل عبر شراكات مع أطراف أخرى، وفق ميسون.
تُظهر بيانات المساعدات الخارجية الأمريكية لهذا العام، تقلص الدعم الموجه إلى قطاع المياه والصرف الصحي في الأردن، من نحو 115.6 مليون دولار في عام 2023 إلى حوالي 40 مليون دولار فقط في العام الجاري.
تقول ميسون: ”هذه المساعدات ’واجب دولي‘ نتيجة أزمات لم يكن الأردن طرفًا فيها، كالحروب والهجرات والتغير المناخي، وبما أن معظم مشروعات المياه الحيوية في الأردن ممولة جزئيًّا من جهات مانحة مثل الوكالتين؛ الأمريكية والفرنسية، فإن استمرار تراجُع التمويل يهدد استدامة هذه المشروعات“.
لتونس تمويل مستقر ولكن
في تونس، لا تزال مشروعات المياه تحظى بدعم منتظم من وكالات التعاون الدولي الأوروبية، ما يمنحها قدرًا من الاستقرار في تنفيذ خططها.
لكن التحديات المناخية المتزايدة تُعقّد الأمر، إذ أسهمت موجات الجفاف المتكررة وارتفاع معدلات البخر في تراجُع كبير بإيرادات السدود، وفق التونسية روضة القفراج، الخبيرة في البيئة والموارد والسياسات المائية.
تقول روضة لشبكة SciDev.Net: ”في السنوات الأخيرة، تبخرت كميات مياه تُعادل سعة بعض السدود قبل أن تصل إلى خزاناتها، ما يحد من قدرتنا على التخزين والاستفادة من الأمطار الموسمية“.
وتضيف: ”الضخ المفرط من المياه الجوفية تسبب في ارتفاع نسبة ملوحتها، ما يمثل تهديدًا مزدوجًا للبيئة والصحة العامة، ويزيد من كلفة المعالجة“.
تحذر روضة كذلك من أن ”تقادُم شبكات التوزيع والتسربات الكبيرة في بعض المناطق يسفر عن خسائر مائية تُقدر بنحو 20% إلى 30% من المياه الموزعة“.
وتضع الدولة آمالًا كبيرة على المخطط الوطني للمياه، الممتد حتى عام 2050، ويصفه رضا قبوج -كاتب الدولة السابق لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري- بأنه ”أحد أضخم البرامج في تاريخ البلاد“، بكلفة إجمالية تناهز 70 مليار دينار (نحو 24 مليار دولار)، يخصَّص نحو نصفها لمشروعات معالجة المياه المستعملة وتوسعة منظومة التحلية.
ويهدف البرنامج إلى استغلال 70% من المياه المعالجة في الزراعة والصناعة وإعادة تغذية الخزانات الجوفية [الموائد المائية]، أيضًا يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية لمحطات التحلية، التي تبلغ حاليًّا 360 ألف متر مكعب يوميًّا، وفق قبوج.
يجري تمويل المخطط الوطني عبر عدة قنوات، أبرزها التعاون مع شركاء دوليين مثل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تشارك في مشروعات إستراتيجية تمتد حتى عام 2050، كما أوضح قبوج. وتسعى الدولة إلى تأمين التمويلات اللازمة من مؤسسات مالية مثل البنك الدولي، إضافةً إلى الشراكة مع القطاع الخاص حال وجود فجوات تمويلية.
من جهته، فإن جواد الخراز -مدير الأبحاث السابق في مركز الشرق الأوسط لأبحاث تحلية المياه في سلطنة عمان، وعضو بالرابطة الدولية لتحلية المياه- يقرر أن ”التمويل الدولي أدى حتى الآن دورًا أساسيًّا في دعم إصلاحات السياسات المائية في تونس، عبر توفير الدعم الفني والتقني إلى جانب التمويل المالي“.
ويؤكد الخراز أن الحفاظ على استمرارية هذه الشراكات ضروري لضمان تنفيذ مشروعات كبرى، مثل مشروع تحلية مياه البحر في قابس ومحطات المعالجة المتقدمة في صفاقس.
وقد تواجه تونس صعوبةً أكبر في الحصول على تمويلات لمشروعاتها المائية مستقبلًا، فمن ثم يرى الخراز أنه ”ينبغي إعداد ملفات فنية ومالية دقيقة لجذب التمويلات الدولية الجديدة، خاصةً من صناديق المناخ العالمية، التي تضع معايير صارمة تتعلق بالجاهزية التقنية والشفافية في الحوكمة“.
الحوكمة غائبة بلبنان والمشروعات معلقة
في لبنان، لا تمثل الندرة الطبيعية للمياه التحدي الأكبر، بل تأتي الأزمة بفعل اختلالات مؤسسية عميقة وعدم وجود إستراتيجيات فعالة لإدارة هذا المورد الحيوي، كما يقول خبير المياه اللبناني فرج الأعور، في حديثه لشبكة SciDev.Net.
”المؤسسات الرسمية المسؤولة عن توزيع المياه لم تُحدِّث بنيتها التحتية منذ التسعينيات، ما يجعلها عاجزةً عن تقديم خدمة منتظمة للمواطنين“، وفق المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ’أعور ووتر‘ الاستشارية الناشئة المعنية بحوكمة قطاع المياه والإدارة المتكاملة للموارد المائية.
”حجم الفاقد المائي بسبب التسرب والسرقات وتهالك الشبكات يتجاوز 50% من كميات المياه المنتجة“.
لمجابهة هذه المعضلة أنجزت الحكومة اللبنانية العديد من المشروعات بالتعاون مع منظمات دولية، أبرزها مشروع طموح بقيمة 73.5 مليون دولار يمتد في المدة من 2021 إلى 2027، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
المشروع يهدف إلى زيادة كفاءة مرافق المياه العامة، بتركيب عدادات ذكية، وتدريب الكوادر الفنية، وتعزيز الشفافية في الفوترة، غير أن المشروع توقّف فجأة -وفق الأعور- بعد قرار إدارة ترامب، مما أحدث فجوةً تمويليةً وفنيةً يصعب سدّها بالإمكانيات المحلية.
يؤكد الأعور أن انسحاب الممولين الدوليين ”لا يؤثر على المشروعات التقنية فحسب، بل يؤدي إلى إضعاف الثقة العامة بالمؤسسات، ويحد من قدرة الدولة على جذب استثمارات مستقبلية“.
ويضيف: ”لبنان لا يعاني شحّ المياه فقط، بل شُح الإرادة السياسية والإدارة الرشيدة أيضًا، التمويل الدولي كان يسدّ ثغرات حيوية، وغيابه الآن يجعل أي إصلاحات مؤسسية مؤجلةً إلى أجل غير معلوم“.
من جهة أخرى، تواصل الوكالتان الفرنسية والألمانية تقديم دعم محدود لبعض مشروعات المياه في لبنان، ”لكن وصول التمويلات يتأخر بسبب البيروقراطية المحلية وعدم وضوح الرؤية الوطنية لإصلاح القطاع“.
كما أن عجز مؤسسات المياه عن تحصيل الفواتير من غالبية المشتركين، خاصةً في المناطق التي تسيطر عليها أطراف سياسية غير رسمية، يعمّق العجز المالي ويجعل حتى التشغيل اليومي صعبًا.
وفق الأعور فإن الحل يكمن في وضع خطة وطنية عاجلة لإعادة هيكلة مؤسسات المياه، تعتمد على استقلالية إدارية ومحاسبة واضحة، بالشراكة مع البلديات والمجتمع المدني، وبدعم تقني وتمويلي دولي، ويحذر: ”وإلا فإن لبنان، الذي كان يزخر بالينابيع والأنهار، قد يواجه أزمة مائية مركبة تشمل الشح، والتلوث، والاحتكار“.
المغرب استبق
يعاني المغرب ندرة مياه بسبب التغيرات المناخية والضغوط السكانية، وقد كان التمويل المقدم من وكالات التعاون الدولية -مثل الوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي- عاملًا حاسمًا في تنفيذ مشروعات مائية إستراتيجية، وفرت هذه الجهات الدعم اللازم لإنشاء محطات التحلية وتطويرها، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وبناء السدود، وتوسيع شبكات التوزيع.
تشير ساندرا روليير -خبيرة إدارة الموارد الطبيعية بالوكالة الفرنسية للتنمية- إلى مشروع سد قدوسة باعتباره من أبرز نماذج تمويلها، بالتعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ، ويهدف إلى تعزيز استخدام المياه السطحية بدلًا من الجوفية، وتحسين كفاءة شبكات الري الزراعي، يضم المشروع كذلك مكونات بيئية واجتماعية، تشمل دعم الواحات المحلية وتطوير نظم زراعية تتكيف مع تغيُّر المناخ.
ورغم هذه الجهود، بدأت آثار خفض موازنات بعض وكالات التعاون الدولي تظهر على بعض المشروعات الصغيرة لتوفير مياه الشرب في المغرب، خاصةً في المناطق الريفية، فقد كشفت تقارير إعلامية عن أن تجميد مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يهدد المشروعات الاجتماعية وسبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
علق مثلًا مشروع توفير مياه الشرب لعدة قرى في جبال الأطلس، ليصبح الوصول إلى المياه النظيفة والآمنة غير مضمون، مما يضطر سكان المجتمعات الريفية هناك إلى قطع مسافات طويلة لتأمين احتياجاتهم من الماء.
في المقابل يؤكد الإعلامي والناشط البيئي المغربي محمد التفراوتي أنه لا توجد مؤشرات واضحة حتى اللحظة على أن تقليص التمويلات الدولية قد أدى إلى تعطيل مشروعات المياه في المغرب، ويضيف للشبكة: ”البيانات تُظهر استمرار هذه المنظمات في دعم المشروعات المائية بشكل نشط، مع التركيز على تعزيز الكفاءة والاستدامة“.
من جانبه، يرى الخراز أن المغرب قدّم نموذجًا ناجحًا في استخدام التمويل الدولي لا لبناء منشآت وبنى تحتية فحسب، بل لبناء قدرات مؤسسية وتنفيذ إصلاحات تشريعية وإدارية طويلة الأمد.
ويضيف: ”المغرب يدرك أن التمويل ليس دائمًا، لذا يسعى لدمج الاستثمار في المياه ضمن إستراتيجياته المناخية، ما يمنحه أفضليةً في جذب تمويلات من صناديق المناخ والتمويل الأخضر الدولي“.
مصر لم تتأثر
تعتمد مصر كثيرًا على التمويلات الدولية لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي، سواء من خلال المنح أو القروض أو الشراكات متعددة الأطراف.
حتى الآن، ورغم التوجهات العامة في أوروبا نحو خفض موازنات التعاون الدولي، لم تسجل مصر تراجُعًا ملحوظًا في مستوى الدعم المخصص لهذا القطاع، وفق عدد من الخبراء.
ففي أبريل الماضي، وقّعت مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي تسع اتفاقيات تمويل ومنحة بقيمة 262.3 مليون يورو، تشمل مشروعات رئيسة في مجالي المياه والطاقة.
من أبرز هذه المشروعات مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة، شرق الإسكندرية، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 70 مليون يورو، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الجبل الأصفر، بتمويل مشترك من الوكالة والاتحاد الأوروبي يبلغ 61.5 مليون يورو، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة، لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه.
كما وقع الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس الماضي شراكة إستراتيجية شاملة، تتضمن حزمة دعم مالي في هيئة قروض ومنح واستثمارات تصل إلى 7.4 مليارات يورو حتى عام 2027، تشمل مشروعات ذات أولوية في الأمن المائي والطاقة المتجددة.
كذلك يؤكد صالح أن الوكالة الهولندية لم تخفض دعمها لمشروعات المياه في مصر، ويقول: ”أدير مشروعًا ممولًا من الجانب الهولندي، وهناك نقاشات جارية بشأن تقديم الدعم لمصر خلال السنوات القادمة، خاصةً في المشروعات التنموية“.
”الاستقرار في التمويل يعود إلى رغبة الجهات المانحة في دعم الأبحاث المرتبطة بمياه الأنهار، وهو ما يميز مصر“، وفق محمد الحجري، الأستاذ المساعد بمركز بحوث الصحراء في مصر والباحث الرئيس في مشروع ممول ضمن ’أفق أوروبا‘، ببرنامج التمويل الرئيسي للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار.
يقول الحجري لشبكة SciDev.Net: ”تمويل المشروع -المستهدف تقديم حلول للمعالجة الحيوية لمياه النهر باستخدام نبات ورد النيل والحصى- يسير بشكل طبيعي، ووفق الجدول المخطط له منذ بدايته قبل عامين“، مشيرًا إلى استمرار طرح برامج تمويلية جديدة، ما يعكس استمرار وتيرة التمويل واستقرارها.
ويعلل الحجري هذا بالإشارة إلى خصوصية البيئة المائية في مصر، قائلًا: ”نهر النيل يمثل مختبرًا طبيعيًّا لاختبار تقنيات معالجة ملوِّثات المياه، في سياق بيئي لا يتكرر بالنمط نفسه في معظم الدول الأوروبية أو شمال أفريقيا، ولهذا تحرص جهات التمويل على دعم هذا النوع من الأبحاث التطبيقية هنا“.
يؤمن على ما سبق علاء الدين حموية، الممثل الإقليمي للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، ويؤكد أن ”تمويل مشروعات المياه التي ينفذها (إيكاردا) في مصر لم يشهد أي تقليص“، لا سيما في ظل اعتماد المركز على مصادر تمويل متنوعة لا تقتصر على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ورغم أن حالة تمويل عدد من المشروعات الممولة من الوكالة لعام 2025 بمصر عالقة الآن، إلا أن ذلك لم يشمل مشروعات قطاع المياه والصرف الصحي.
يعد حموية الخصوصية التي تميز إدارة المياه في مصر، وبالأخص ارتباطها الوثيق بنهر النيل، سببًا في جعلها محورًا مهمًّا للتمويلات الدولية، خاصةً في ظل التحديات التي فرضها سد النهضة الإثيوبي، والتي دفعت الحكومة المصرية إلى تبنِّي إستراتيجيات بديلة، تشمل تحلية المياه، ومعالجة المياه الرمادية، واستغلال المياه الجوفية، وهي مشروعات تتطلب دعمًا دوليًّا مستدامًا ومكثفًا.
دعم مشروط وأولويات مختلفة
والحاصل أن المشهد بالمنطقة يعكس مزيجًا من التحركات الاستباقية والاعتماد النسبي على التمويلات الأجنبية، غير أن الخبراء يُجمعون على أن استمرار أي إستراتيجية مائية طويلة الأمد لا يزال يعتمد جزئيًّا على توافُر دعم خارجي، خاصةً في ظل تفاقُم الضغوط على الموارد المحدودة.
ورغم عدم تسجيل تأجيلات كبيرة في تنفيذ مشروعات المياه حتى الآن في مصر والمغرب وتونس، إلا أن الخطر يكمن في المدى المتوسط؛ إذ يعتمد الثلاثي على تمويلات تُوجه إلى عدة قطاعات، وإذا تقلص الدعم، فقد يُضطر المانحون إلى إعادة تخصيص الموارد وفق أولويات مختلفة.
في هذا السياق، يوضح كارلوس ألبرتو أرياس -باحث أول بمركز تكنولوجيا المياه في جامعة آرهوس الدنماركية- أن ”التمويل الأوروبي غالبًا ما يُدار وفق أولويات سياسية للمانحين، لا احتياجات المتلقين، وعلى سبيل المثال الوكالة الإسبانية تفضل دعم أمريكا اللاتينية، أما الوكالة الدنماركية فتركز على ملفات البيئة وحقوق الإنسان“.
ورغم هذا، يرى أرياس -الذي باشر عددًا من المشروعات المائية الممولة من جهات أوروبية- أن التمويل ما زال متاحًا، عبر برامج مثل ’أفق أوروبا‘ و’الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط- بريما‘، وصناديق أخرى مثل ’البوابة العالمية‘ و’الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل أفريقيا‘، ”لكنه مشروط بتكوين تحالفات قوية وتقديم مقترحات تنافسية“.
ويقرر أن أحد العوائق الرئيسة هو ”ضعف الظهور“، مشيرًا إلى أن الأوروبيين لا يدركون جيدًا إمكانيات الباحثين الأفارقة، مما يضعف فرص التعاون، داعيًا إلى تعزيز برامج التنقل الأكاديمي مثل ’إيراسموس بلس‘ لردم هذه الفجوة.
صناديق وتمويلات لا تُستغل كفاية
من جانبه، يدعو حسن أبو النجا -نائب رئيس منتدى الشرق الأوسط للمياه- إلى ضرورة التوجه نحو صناديق المناخ العالمية، مثل صندوق التكيف وصندوق المناخ الأخضر، طلبًا للدعم، خاصةً في مشروعات التكيُّف مع آثار التغيُّر المناخي في مجالات الري والتحلية وإعادة استخدام المياه.
ويقول أبو النجا لشبكة SciDev.Net: ”حتى نستفيد من هذا التمويل، لا بد أن تكون المشروعات مصممة لخدمة أجندة المناخ، لا أن تكون مشروعات بنى تحتية تقليدية يعاد تغليفها بمصطلحات بيئية“.
كما يلفت إلى أهمية استثمار التمويل العربي والأفريقي، مثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، وهي جهات داعمة من أجل بنية تحتية مرنة وزراعة ذكية مناخيًّا.
ويؤكد أبو النجا ضرورة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص عبر نماذجها مع القطاع العام لتقليل العبء المالي على الحكومة، مع تحسين البيئة التشريعية.
تمويلات أكثر استدامة وبدائل داخلية فعالة
يشير أرياس إلى تحولات تدريجية في نماذج التمويل، حيث ”المنح التقليدية ستتراجع نسبيًّا، وسيحل محلها التمويل المشترك، والشراكات، وحتى تمويلات من جهات غير تقليدية كالمؤسسات الدينية“.
ويرى أرياس أن التركيز العالمي يتحول من مشروعات البنية التحتية الكبرى إلى دعم الابتكار وبناء القدرات، مؤكدًا أهمية وجود فرق محلية مؤهلة تبحث عن الفرص التمويلية، وتُعد مقترحاتٍ قويةً تستند إلى فهم اقتصادي وتقني.
ويدعو إلى ”المشاركة في فعاليات الاتحاد الأوروبي ومنصاته لبناء الشراكات“.
يؤكد الخطيب أن الأثر الحقيقي لا يتمثل في توقف بعض المشروعات فحسب، بل في التحولات الهيكلية التي تجعل المساعدات مشروطةً بالمصالح القومية للدول المانحة، ويحذر من أن ”شح المياه قد لا يؤدي إلى نقص الإمدادات فقط، بل إلى اضطرابات اجتماعية، لا سيما بين المجتمعات المضيفة للاجئين، خاصةً في الأردن ولبنان“.
بالتوازي يؤكد الخبراء العرب أن تقليص الدعم الخارجي يجب أن يُقابل بإصلاح داخلي، يتضمن تبنِّي أنظمة ري حديثة، وزيادة الاستثمار في معالجة المياه، وتوسيع استغلال موارد المياه غير التقليدية، ومشروعات تحديث الشبكات المتهالكة وتحسين صيانة المنشآت.
ويشير صالح إلى أن ”المشكلة ليست في فقر دولنا مائيًّا فقط، بل في سوء إدارتها، ففي بلد مثل الأردن، تتراوح نسبة الفاقد بين 46% و70%“.
وفي تونس، تؤكد روضة أن ”تقليص فاقد المياه بنسبة 10% يمكن أن يوفر نحو 80 مليون متر مكعب من المياه سنويًّا، وهي كمية تعادل تقريبًا إنتاج سد جديد“.
كما يؤكد الخطيب أن ”الزراعة تستهلك أكثر من 70% من المياه في المنطقة، ومعظمها يدار بأساليب تقليدية“، مؤكدًا أهمية التحول إلى زراعات أقل استهلاكًا للماء وتقنيات ري حديثة.
هذه البدائل، وإن بدت طموحة، فهي تمثل مداخلَ ضروريةً لحلول طويلة الأمد، شرط توافر الإرادة السياسية والانفتاح على نماذج التمويل غير التقليدية، وتوسيع قاعدة الشراكات إقليميًّا ومحليًّا.
ويختتم الخطيب: ”قطع التمويل الدولي قد لا يكون شرًّا مطلقًا، بل فرصة لإعادة التفكير في إستراتيجيات وشراكات جديدة لتمويل مشروعات المياه في المنطقة“.