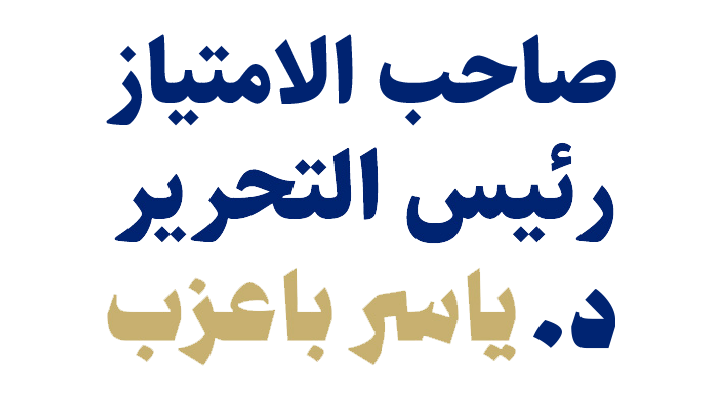قراءة استراتيجيّة في التهديدات الحوثية المُبطّنة للسعودية
بقلم: مصطفى محمود
لا يمكن فهم السلوك الحوثي اليوم من زاوية الخطاب وحده؛ فالجماعة تبني حساباتها على قناعة بأن كتلة النفوذ التي ارتكزت عليها خلال السنوات الماضية لا تزال ثابتة.. لكنها ليست كذلك، هذه الكتلة تتعرّض لإعادة ضبط صامتة، شبيهة بعمليات إعادة المعايرة التي تجري داخل أجهزة حساسة: لا تُرى، لكنها تغيّر النتائج بالكامل، ويبدو أن الحوثيين يتصرفون كما لو أن المعادلة القديمة ما زالت تعمل، رغم أنها لم تعد موجودة فعليًا.
السعودية، من جانبها، تحافظ على درجة منخفضة من الانفعال. ليس لأن الأمر لا يعنيها، بل لأن إدارة الزمن — كما يحدث في ملفات طويلة الأمد — تتجاوز ردّ الفعل المباشر.. هذا النوع من الهدوء، الذي قد يبدو “عدم اكتراث” لمن يراقبه من الخارج، يشير في الواقع إلى انتقال في طريقة التعامل مع الملف اليمني: من المواجهة المفتوحة إلى إدارة النفوذ بالتحكم في الهامش لا في المركز. وهي طريقة تتطلب صبرًا باردًا، ومساحة انتظار محسوبة.
المشهد اليمني يتحرك داخل مجال قوى أكبر من حجمه الداخلي. التعديلات الإقليمية الأخيرة — خصوصًا بين الرياض وطهران — لا تُصنع عبر تصريحات أو رسائل صارخة، بل عبر إعادة توزيع للقوة بطريقة لا تحتاج إلى ضجيج.. هنا بالتحديد يتعرض الحوثيون لضغط غير مباشر، لكنه ثقيل.. فهم يواجهون الآن حدودًا لم تكن موجودة قبل سنوات؛ الحدود التي تظهر عندما تنكمش قدرات الممول الرئيسي.
ولأن الإشارات الداخلية تُقرأ عادةً أسرع من الإشارات الخارجية، فقد انعكس هذا التحول على خطاب الجماعة.. التهديدات الموجهة للسعودية لا تُظهر ثقة، بل رغبة في حماية مساحة سياسية تتقلص تدريجيًا.. بعض الجمل التي تصدر عن قيادات الصف الثاني والثالث تُقرأ كأنها كتبت على عجل، بلا مراجعة، وهذا يشي بشيء غير معلَن داخل مركز القرار: شعور بأن الغطاء الإقليمي لم يعد صلبًا كما كان.
السعودية، بالمقابل، انتقلت إلى معادلة مختلفة. لم تعد معنية بإسقاط الجماعة، ولا بإعادة تدوير الساحة اليمنية من خلال شبكات النفوذ التقليدية: قبائل، أحزاب، وسطاء.. يتجه التفكير الآن نحو نموذج أكثر انتظامًا: بناء علاقة مع “دولة” لا مع “وسطاء”، النموذج يبدو تقنيًا، لكنه في صلبه محاولة لتقليل الفوضى التي حكمت الملف اليمني لعقود.. هنا يظهر ما يمكن تسميته — على سبيل التشبيه فقط — تحولًا من نفوذ سائل إلى آخر مُهيكل.
على الجانب الإيراني، تتغير الحسابات أيضًا. النقاشات الداخلية التي تتسرب إلى العلن — حول الكلفة الاقتصادية، تراجع العوائد، وحتى الضغوط المرتبطة بالمياه والبنية التحتية — لا تعبر عن لحظة ضعف مفاجئة، لكنها تشير إلى إعادة ترتيب أولويات، هذا النوع من الترتيب ينعكس أولًا على الأطراف البعيدة: حيث يصبح تقليص النفقات على الوكلاء خيارًا منطقيًا، وأحيانًا ضروريًا.. الحوثيون يشعرون بهذا قبل غيرهم، وربما لهذا السبب يظهر ذلك الارتجاف الخفيف في خطابهم.
في هذه البيئة، أي قراءة للتهديدات الحوثية تجاه الرياض يجب أن تُدرج ضمن نمط أكبر. فالسعودية لا تُظهر ردودًا لفظية.. نمطها قائم على تحويل الرسالة إلى تقييم، ثم بناء خطوة تنفيذية بلا إعلان مسبق.. الخطر يكمن في سوء الفهم: خطوة يظن الحوثيون أنها محسوبة قد تُترجَم في الرياض إلى تجاوز يستدعي ردًا مختلفًا تمامًا عن أدوات العقد الماضي. وهذا احتمال لا يلتفت إليه الخطاب الحوثي، أو يتفادى الاعتراف به.
السيناريو الأول: استمرار الرفض المسلح
تستمر الجماعة في التمسك بالسلاح ورفض الانخراط السياسي. السعودية تُضيّق اقتصاديًا، تستخدم ردعًا محدودًا، وتوسع دائرة دعم الشرعية. يحدث الاستنزاف ببطء، لكن بثبات، بينما تتقلص قدرة إيران على التعويض. ويظهر ضغط داخلي على الجماعة، ليس مفاجئًا، بل نتيجة تراكمية.
السيناريو الثاني: مشاركة محدودة دون تفكيك السلاح.. قبول بدور إداري مقيد، تحت إشراف الدولة اليمنية. السعودية تقدم حوافز مشروطة، لكنها تحتفظ بأدوات الضغط الفاعلة.. النتيجة هي استقرار موضعي: لا يمنح الجماعة هيمنة، ولا يسمح بانهيار كامل. وضع قابل للإدارة، وإن كان هشًا بطبيعته.
الخلاصة.. لا يتحرك الملف اليمني وفق رغبات الأطراف، بل وفق المسار الإقليمي الذي يعيد ترتيب نفسه حاليًا. الخيارات أمام الحوثيين لا تشمل الهيمنة أو الانخراط الكامل؛ تشمل فقط كيفية التعامل مع عملية تآكل بطيئة في مصادر نفوذهم. المسألة الآن ليست “إلى أين يذهبون؟” بل “كيف سيبدون حين يصلون؟”، البقية تحددها الهندسة الإقليمية، لا الخطاب.