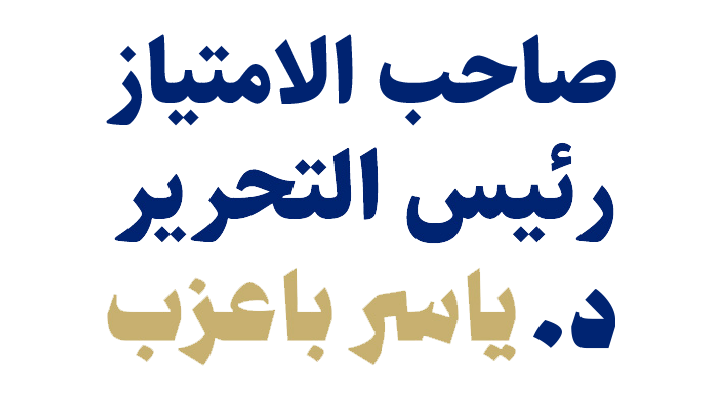الأمن الغذائي: عبادة وعُمران ومسؤولية حضارية
في عالم يموج بالأزمات والتحديات، باتت قضية الأمن الغذائي من أكثر ما يُقلق العقول ويشغل الضمائر. من الجفاف والحروب، إلى الأزمات الاقتصادية؛ أصبح تأمين لقمة العيش أمرا يستوجب وقفة جادة وتأملا عميقا. وهنا يبرز الإسلام، لا بوصفه دينا للعبادة فقط؛ بل كنظام حياة شامل، لم يغفل قيمة الغذاء ولا دوره في كرامة الإنسان وبقائه.
الغذاء في التصور الإسلامي ليس مجرد حاجة مادية؛ بل هو نعمة إلهية ومسؤولية حضارية. قال تعالى: ﴿فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ﴾ [عبس: 24]، إنها دعوة إلهية لتأمل رحلة الطعام: من الزرع إلى الحصاد، ومن الإنتاج إلى الاستهلاك. إنها لحظة وعي وامتنان، تُذكرنا بأن كل لقمة نحملها إلى أفواهنا هي فضل من الله، تستوجب الشكر والتدبير.
يعرف الخبراء "الأمن الغذائي" بأنه "توافر الطعام، وسهولة الوصول إليه، وسلامته الصحية". وهذا التعريف، حين نقرأه في ضوء الشريعة الإسلامية، نكتشف أنه متجذر في مقاصدها الكبرى: حفظ النفس والعقل والنسل.
وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم امتلاك القوت اليومي من أعظم نعم الله، فقال: «من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا» (رواه الترمذي). وهذا الحديث يلخص لنا مفهوم الاكتفاء وطمأنينة العيش في أبسط صوره.
ليس تأمين الغذاء مهمة فردية فقط؛ بل هو مسؤولية جماعية، تشترك فيها الدولة والمجتمع معا. وقد تجلّت هذه المسؤولية في سلوك الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي عانى مع الناس الجوع في عام الرمادة، وكان لا يذوق السمن حتى يشبع آخر فرد من المسلمين. ولعل كلمته الخالدة: "لو أن بغلة عثرت في العراق، لكنت مسؤولا عنها"، تضعنا أمام مفهوم عميق للمحاسبة والضمير الإنساني الحي.
ويُستفاد من سير الخلفاء أن التخطيط الزراعي، وتوفير المياه، ودعم الفلاحين، وفتح الأسواق، كلها أدوار محورية للدولة؛ بل إن الإسلام حذر من الاحتكار، واعتبره جرما، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ» (رواه مسلم).
حين تمشي بين سنابل القمح، أو تشاهد شجرة تُثمر؛ تذكّر أن في ذلك عبادة! فالزراعة في الإسلام ليست مجرد مهنة تُمارس لكسب العيش؛ بل هي عمل صالح تُرجى به الحسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة» (متفق عليه).
وقد سار الصحابة على هذا النهج، فكان الزبير بن العوام من كبار ملاك الأرض، وكان ابن عمر يُوصي بزراعة أراضيه وعدم تركها بورا؛ فالزراعة في منظورهم لم تكن ترفا بل واجبا وعمرانا.
ويؤكد القرآن هذا المعنى بقوله تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61]، أي طلب منكم إعمار الأرض؛ لا بتشييد المباني فقط؛ بل بخدمتها وزراعتها وتحقيق النفع منها.
كثيرا ما نُركّز على وفرة الغذاء، وننسى أن طريقة استهلاكنا له جزء لا يقل أهمية عن إنتاجه؛ فالإسراف والتبذير والتعامل مع الطعام بلا تقدير؛ كلها عوامل تهدد الأمن الغذائي. قال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأعراف: 31].
وكم من نعمة أُهدرت في المناسبات والولائم، وكم من طعام ألقي في القمامة بينما غيرنا جائع! وهنا تتجلى حكمة عمر بن عبد العزيز حين قال: "الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة". والاقتصاد لا يعني الشح؛ بل يعني حسن التدبير، والبعد عن الهدر.
ما يهدد غذاءنا اليوم ليس نقصا في الموارد فقط؛ بل جملة من التحديات المتشابكة؛ منها: التغيرات المناخية، الحروب، التصحر، التلوث، وسوء الإدارة... وكل هذه تحتاج إلى مواجهة بعقل مؤمن، وروح متعاونة، وسياسات واعية.
والإسلام لا يدعونا إلى الركون؛ بل إلى التخطيط والتعاون. فالتوكل لا يعني التواكل. وقد دعا العلماء إلى ضرورة تكامل الجهود بين الدول الإسلامية، وتبادل الخبرات الزراعية، والاستثمار في البحث العلمي والتقنيات الزراعية الحديثة.
وكما قال ابن خلدون: "الزراعة أصل العمران، ومتى ضعفت الزراعة ضعف ما ينبني عليها"، فإن من أراد نهضة أمته؛ فليبدأ من التربة والماء والبذرة.
والخلاصة: أن الأمن الغذائي في الإسلام ليس مجرد قضية تنموية أو مشروعا اقتصاديا؛ بل هو عبادة نؤجر عليها، وأمانة سنُسأل عنها، وعمارة للأرض نُخلّد بها. ومن حمل همّ الأمة، وسعى لسد جوع فقير، أو علّم الناس كيف يزرعون ويُنتجون، أو دافع عن موارد بلاده؛ فهو في جهاد حضاري لا يقل أجرا عن من يحرس حدود الوطن.
فلنُعد النظر في عاداتنا، ولنُحيِ ضمائرنا، ولنتعامل مع النعمة بوعي وشكر.
ونسأل أن يجعلنا من الشاكرين لنعمه، الساعين في خدمة خلقه، وأن يرزقنا الحكمة والتدبير...
ودامت ديارنا عامرة بالخير.
ودمتم سالمين.