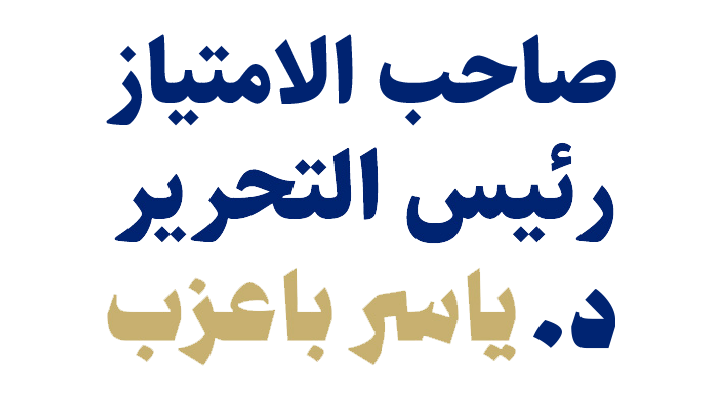متى نراجع أنفسنا؟
المشكلة في الجنوب بدأت منذ لحظة الثورة نفسها. حين اندلعت ثورة 14 أكتوبر، وسارت نحو الاستقلال الوطني، تصدّر المشهد ثوار “التصفية”، الذين لم يكتفوا بطرد المستعمر، بل طردوا أيضًا الأحرار من أبناء الجنوب، ودمّروا كل الشركات والبنى التحتية التي كانت موجودة – وإن كانت بقايا عهد بريطاني – فتركت البلاد في حالة “صفر”، أشبه بخزينة البنك المركزي اليمنى الذي اصبح خالي من الموارد المالية .
بعدها بدأت التصفيات الجسدية. فُتحت السجون، وبدأت الاعتقالات والتعذيب والتنكيل بكل مخالف، ولم ينجُ إلا من استطاع الهرب أو أُجبر على مغادرة البلاد. كل فئة كانت تنتصر في انقلاب، وتفرض رؤيتها بالقوة، حتى وصلنا إلى أحداث 13 يناير، يوم الدم.
هربت “الشلة” إلى الشمال، بينما بقي جزء في الجنوب. وبعد تلك الفوضى، جاءت الوحدة اليمنية، وكان من شروط بعض القيادات، مثل علي سالم البيض، أن تُستبعد الزمرة المقابلة لهم مقابل توقيع الوحدة. كان ذلك من مصلحة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي استخدم هذه الخلافات لتعميق سيطرته. رحب بالبعض، وطرد الآخرين، حتى شمل الطرد الرئيس السابق علي ناصر محمد وآخرين.
في عام 1994، استخدم علي عبدالله صالح الزمرة المهزومة كذريعة، وشنّ الحرب، ليُكمل مشروع احتلال الجنوب، مستفيدًا من صراعات الجنوبيين أنفسهم. فكان الانتصار للشرعية، لكن على حساب الجنوب وأهله. ومن تلك اللحظة استمر الصراع داخل الجنوب على “قدم وساق”.
جاءت ثورة 2015، وبدا وكأن حلم الجنوب سيعود، لكن ما حدث هو أن المنتصر – فئة مناطقية قبلية لها ارتباطات سابقة بالحزب الاشتراكي والحوثيين – بدأ بتصفية من وقفوا مع الشرعية، وفتح السجون والمعتقلات، وصادر الممتلكات، واستولى على الشركات والضرائب، وجوّع الناس، وأهلك الحرث والنسل، واعتبر نفسه الوريث الشرعي الوحيد للثورة.
أصبح معيار “الثائر” هو من مارس التصفيات، ومن لم يمارسها فليس بثائر. وهكذا استمرت الدائرة: ثورة تعني تدمير ما قبلها، وفتح سجون، وقتل شرفاء.
( لمحللين أو سياسيين) يقول: المحافظات الجنوبية الشرقية خرجت من تحت السيطرة، الجنوب تمردت على الجنوب، ولكن هل نعدّ هذا في ميزان الانتصارات والبطولات؟ هل الثورة تعني القمع والإقصاء؟ هل صرنا نُسلّم أن “الحق الثوري” لا يُكتمل إلا بتدمير الخصم وسحقه؟
متى نراجع انفسنا ؟