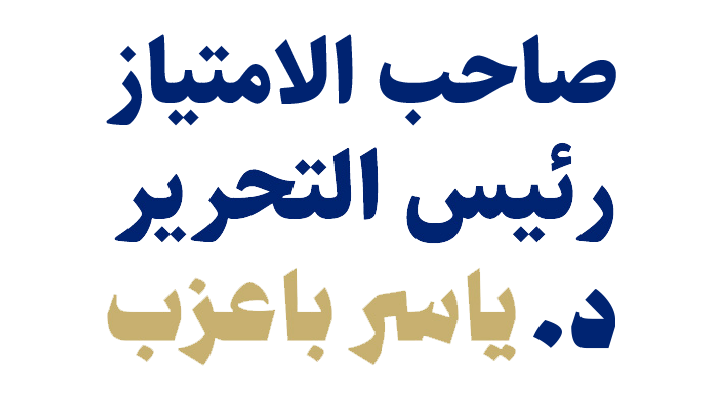خيانة المثقف.. من ضمير الأمة إلى ظل السلطة
ليست خيانة المثقف فعلًا عابرًا أو موقفًا فرديًا فحسب، بل هي تمظهر لأزمة عميقة في العلاقة بين الفكر والسلطة، بين الكلمة والمصلحة، وبين النخبة والجمهور. وحين يُخلف المثقف وعده التنويري والنهضوي، لا يخذل شخصًا أو تيارًا، بل يخون التاريخ الذي انتدبه ليكون شاهده، ويخون الجماعة التي كانت تعوّل عليه ليضيء دروبها.
من هو المثقف؟ وما دوره؟
في جوهره، لا يُقاس المثقف بعدد الشهادات أو الكتب، بل بقدرته على مقاومة البديهيات الزائفة، والتمسك بالبعد الأخلاقي للفكر، ورفض التماهي مع القوة أو السوق. وقد عبّر إدوارد سعيد عن ذلك بدقة حين رأى المثقف “منفيًا داخليًا”، لا يستقر في قوالب السلطة أو الامتياز، بل يعيش توترًا أخلاقيًا مع محيطه بوصفه مسؤولية لا رفاهية.
أشكال الخيانة: من الصمت إلى التزييف
خيانة المثقف لا تبدأ بالتوقيع على بيانات السلطان، بل بالصمت حين تُطلب منه الكلمة، وبالتحايل اللفظي حين يحتاج الناس للوضوح. وقد يرتدي الخائن عباءة الحياد ليوازن بين الضحية والجلاد، أو يتذرّع بالحكمة ليبرر الخنوع، أو يوظّف الخطاب الهوياتي لتسويق الكراهية.
حين يُستبدل الضمير بالمصلحة، والمنبر بالبوق، تتحوّل الخيانة إلى نمط وجودي. فيبيع بعضهم القلم لمن يدفع، أو ينزلق آخرون إلى تمجيد الاستبداد تحت لافتات “الاستقرار”، متناسين أن ما لا يُنتقد لا يتطوّر، وأن ما لا يُكشَف لا يُصلَح.
البنية المنتجة للخيانة
في كثير من السياقات السلطوية، لا تكون خيانة المثقف مجرد خيار فرديًا، بل نتيجة منظومة تُصنع فيها “نخب معتمدة”، تُمنح المنابر والمكافآت بشرط الولاء. فالإعلام الموجّه، والدعم المالي المشروط، والبيروقراطيات الأكاديمية، كلها تُسهم في قولبة الفكر وإخضاعه.
أما الأصوات الحرة، فتُقصى وتُشوَّه وتُحاصَر، حتى يصبح مجرد البقاء في الحقل الثقافي نوعًا من الصمود البطولي. وهكذا تُنتج المجتمعات نخبًا فكرية مطواعة بدل أن تنتج مثقفين مقاومين.
جوليان بندا: التنبيه المبكر
في كتابه الشهير “خيانة المثقفين” (1927)، ندّد جوليان بندا بانخراط النخب الثقافية في الخطابات القومية والعنصرية في أوروبا، معتبرًا أن المثقف الحقيقي هو من ينحاز إلى القيم الكونية، لا إلى المصالح الضيقة، وأن خيانته تبدأ حين يستبدل المبادئ بالمنافع. وقد وجد هذا الطرح صداه في السياقات العربية لاحقًا، حيث تكرّست أنماط من المثقفين الذين يضفون شرعية على التسلط باسم الوطنية أو الدين أو الواقعية السياسية.
العروي والجابري: تفكيك أزمة المثقف العربي
لم يكتفِ عبد الله العروي ومحمد عابد الجابري بتشخيص أزمة النخب السياسية، بل وجّها نقدًا جذريًا للمثقفين أنفسهم. فالعروي، في الإيديولوجيا العربية المعاصرة، فضح انتقائية المثقفين العرب تجاه مفاهيم الحداثة، معتبرًا أن كثيرًا منهم تبنوا قشورًا تحديثية دون فهمٍ عميق، فخدموا ـ عن وعي أو عن جهل ـ خطاب السلطة وتكرار التخلف.
أما الجابري، فقد حلل ما أسماه “العقل المستقيل”، مؤكدًا أن البنية المعرفية السائدة، إضافة إلى ثقل الموروث وسلطة الدولة، ساهمت في تطويع المثقف وتحويله إلى مبرّر لا ناقد. وحين كان يُنتظر من النخب أن تتصدر لحظة المواجهة، انكفأت وارتدت إلى لحظة التبرير أو الخوف.
بين الخوف والانتهازية
ثمة مثقفون يتوارون بدافع الخوف، وآخرون يتورطون في التزييف طوعًا. الفرق بينهما كبير: الأول يمكن فهمه دون تبرير، أما الثاني، فهو الذي يحوّل الثقافة إلى خدمة مدفوعة الأجر، ويبيع المواقف وفق الطلب، ويتحول إلى “تكنوقراط فكري” لا يُنتج معرفة بل أدوات سلطة.
الحاجة إلى المثقف المقاوم
في زمن الاستقطاب، والاستبداد الناعم، وصناعة الوعي المضلل، نحن بحاجة إلى مثقف لا يسكت حين يصمت الجميع، ولا يُجمّل حين يزيّف الآخرون، ولا يساوم حين تكون الكلمة موقفًا. نحتاج إلى من يرى التنوير رسالة لا سلعة، والنقد واجبًا لا خيارًا. فخيانة المثقف لا تُقاس بمدى اقترابه من السلطة، بل بمدى ابتعاده عن الضمير.