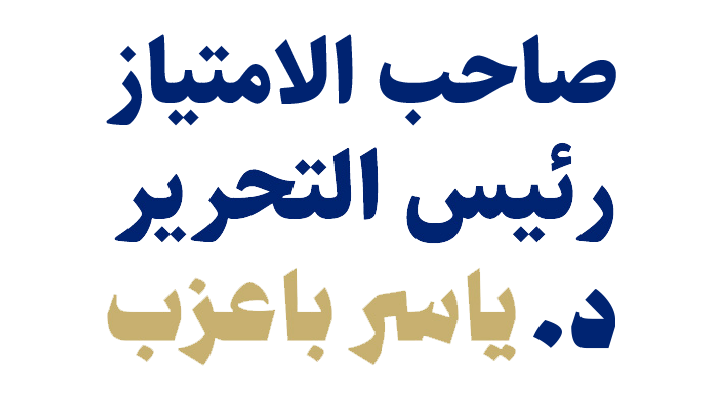«آيديولوجيا الغياب… وحاجة العرب إلى سردية تأسيسية جديدة»
في الخطاب العربي كثيرًا ما تتردّد المقولة بأن أزماتنا سببها وفرة الآيديولوجيات، من قومية واشتراكية إلى ماركسية وإسلام سياسي. غير أن التاريخ يثبت عكس ذلك تمامًا: مأزقنا لم يكن يومًا في تضخم الفكر، بل في غيابه. ما عشناه لم يكن إنتاجًا لنظريات كبرى تُؤطِّر الدولة والمجتمع وتربطهما بعالمهما، بل شعارات ممزقة، ومشاريع مستوردة مشوّهة، وزعامات فردية سلطوية ادّعت أنها أيديولوجيات وهي في الحقيقة بدائل هشّة.
فراغ سردي مزمن
لم يعرف العالم العربي مشروعًا تأسيسيًا يربط الفرد بمجتمعه والدولة بتاريخها ومستقبلها. الجامعة العربية لم تتحوّل إلى إطار فاعل، والتجارب القومية أو الإسلامية بقيت أسيرة الشعارات أكثر من كونها مشاريع فكرية ومؤسساتية متكاملة. حتى إسهامات مفكرين كبار كالجابري والعروي وطه حسين والمرنيسي ظلّت قراءات نقدية ثرية، لكنها لم تُنتج سردية جامعة تؤسس لشرعية حديثة أو لإطار مشترك يلمّ شتات الأمة.
لهذا، حين انهارت دول مثل ليبيا واليمن والصومال، لم يكن السبب صراع الأفكار، بل غيابها. الفراغ الفكري والسياسي كان أخطر من أي تضارب في الرؤى.
دروس من أوروبا وآسيان
التجربة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية تؤكد أن الأزمات الكبرى يمكن أن تتحول إلى انطلاقة جديدة إذا وُجدت سردية جامعة. الاتحاد الأوروبي لم يكن مجرد ترتيبات اقتصادية، بل مشروع حضاري أعاد تعريف معنى الانتماء الأوروبي.
وفي جنوب شرق آسيا، انطلقت منظمة «آسيان» من رؤية اقتصادية عملية: التنمية المشتركة والانفتاح على السوق العالمي. ومع مرور الوقت، تحوّلت هذه الرؤية إلى سردية ثقافية وسياسية منحت شعوب المنطقة إحساسًا متزايدًا بالانتماء إلى فضاء واحد.
نحو أيديولوجيا عربية جديدة
اليوم، يقف العرب أمام فرصة مماثلة. فالماضي القومي لم يعد صالحًا، والإسلام السياسي لم يقدّم مشروعًا قابلًا للحياة، والماركسية العربية ظلت استنساخًا هشًّا. أمام هذا الفراغ، نحن بحاجة إلى خطاب تأسيسي جديد يقوم على ثلاثة أعمدة:
1- الاندماج الاقتصادي: تحويل السوق العربية المشتركة إلى واقع ملموس عبر تحرير التجارة وربط الموانئ والمطارات وشبكات الطاقة. الاقتصاد هنا ليس مصلحة آنية فقط، بل حامل لشرعية جديدة تبرّر الوحدة وتؤسس لمؤسسات قوية.
2- النهضة التعليمية والمعرفية: إصلاح جذري للتعليم والجامعات ومراكز البحث، يجعل الرقمنة والذكاء الاصطناعي في قلب المناهج، ويعيد الاعتبار للفكر النقدي والفلسفة كأدوات تأسيسية لا كترف ثقافي.
3- هوية ثقافية منفتحة: سردية جامعة تعترف بالتنوع وتستوعبه، على غرار ما فعلته أوروبا حين دمجت هوياتها المختلفة في مشروع حضاري واحد. الهوية العربية ينبغي أن تكون إطارًا مرنًا يُنتج سرديتنا الرقمية ويمنحنا القدرة على التفاعل مع العالم بثقة.
عصر الرقمنة كإطار تأسيسي
إن الانتقال إلى اقتصاد المعرفة والرقمنة يفرض نفسه كأرضية مناسبة لبناء مشروع عربي جديد. فالعالم لم يعد يُدار بالشعارات التقليدية أو الحدود الضيقة، بل بمن يمتلك أدوات التكنولوجيا والتكامل الرقمي. وإذا صغنا خطابًا تأسيسيًا يجعل من الرقمنة والاندماج الاقتصادي قاعدة مشتركة، فإننا نعيد صياغة شرعيتنا السياسية والاجتماعية ونستعيد موقعنا في التاريخ.
خاتمة: من النقد إلى البناء
لقد أصاب مأمون فندي حين وصف حالنا بفراغ الأيديولوجيا، لكن لحظتنا الراهنة تتطلب ما هو أبعد من التشخيص. نحن بحاجة إلى خطاب تأسيسي يُقحم العرب في عصر الاندماج الاقتصادي والنهضة المعرفية، ويجعلهم شركاء في ثورة الرقمنة العالمية لا متفرجين على أطرافها.
فإما أن نؤسس لسردية جديدة تليق بتاريخنا وتفتح آفاق المستقبل، أو نظل عالقين في فراغ شعارات الماضي